تدوينة⎮العلاقات الجزائرية-الفرنسية : تطوّر متقلب على مرّ الزمن !
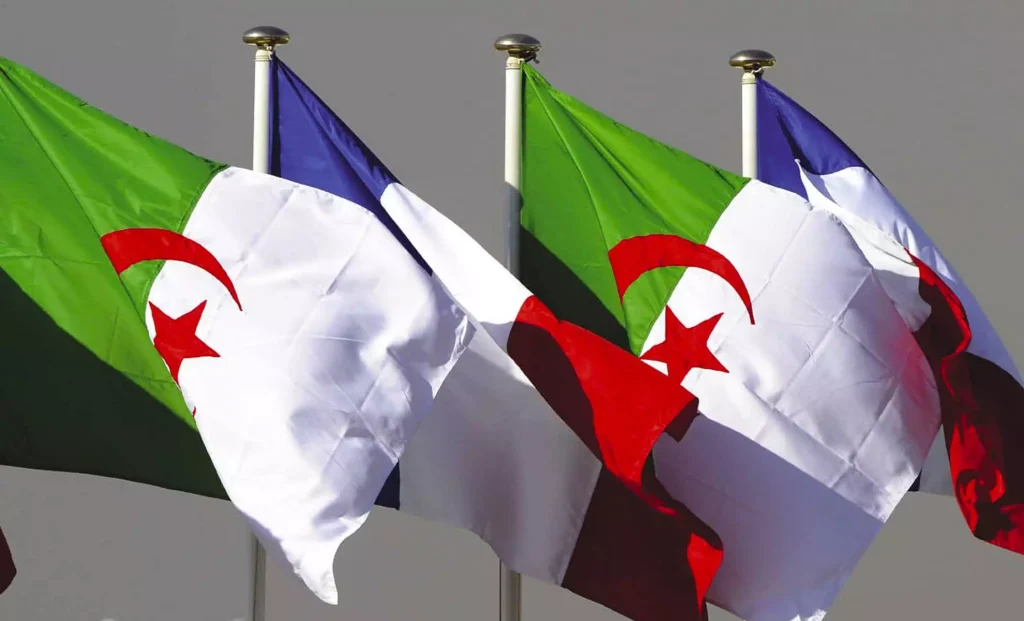
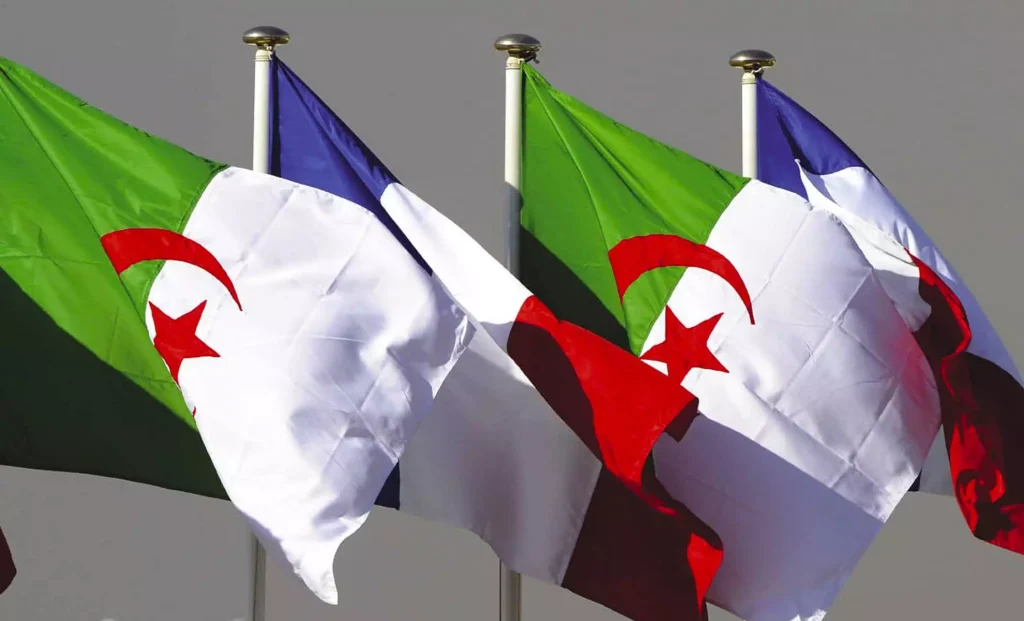
شهدت العلاقات الجزائرية-الفرنسية دائمًا تطورًا متقلبًا، تميز بفترات من التعاون والثقة وحتى الأخوة، تلتها فترات من التوتر والشك والصدامات، والفترة الحالية ليست استثناءً عن هذا النمط.
غير أن الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا تختلف عن سابقاتها من حيث ثقل أصوات مزدوجي الجنسية والتغطية الإعلامية الاستثنائية للمواضيع المثارة. وقد وصل الأمر بوزير الداخلية الفرنسي، ب. ريتايو، إلى اقتراح مصادرة ممتلكاتنا العقارية والمالية، ومنع الخطوط الجوية الجزائرية من تسيير رحلات نحو فرنسا، متجاهلًا في الوقت نفسه شركة "إير فرانس".
ومن خلال هذا المنظار، يجب تحليل الانزلاقات في الأزمة الحالية، بما في ذلك استدعاء السفراء وطرد الدبلوماسيين من الجانبين. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت التصريحات العنيفة، ولو بشكل غير مباشر، من طرف رجال السياسة ووسائل الإعلام التي يهيمن عليها ممولو اليمين المتطرف، أمرًا شائعًا. لذلك، يجب أن نتوقع تصاعد خطابات الكراهية والهجمات المتعددة الاتجاهات على بلدنا ومصالحه الحيوية، إلى غاية عام 2027.
اليمين المتشدد واليمين المتطرف لهما فرصة تاريخية للفوز في الانتخابات الرئاسية شريطة الحفاظ على هذا الخطاب القائم على الخوف والكراهية، بل وتشديده لتحقيق أهداف سياسية. أما الوسط واليسار، فلن تكون لهما فرصة للفوز إلا في حال توحدا على برنامج أدنى، وهو أمر غير سهل المنال. وخلال هذه المرحلة، ستكتفي الجزائر بعدّ النقاط!
إن إصدار كتاب جديد عن الجزائر من طرف كزافييه دريونكور يندرج في هذا الإطار ويؤكد ما تنبأنا به منذ صدور كتابه الأول المعنون بـ"اللغز الجزائري"، وهو أنه مُكلف بمهمة جديدة من طرف "الصندوق الأسود".
وإن الظهور الإعلامي المتكرر لهذا المتقاعد في مهمة مكلّفة، وتدخله في كل القنوات الفرنسية والصحافة المكتوبة، حاملًا صفة "سفير سابق" (مرتين) في الجزائر، لا يمكن أن يكون محض صدفة، بل يجب اعتباره شكلًا من أشكال الاتصال المموّه لتمرير رسائل للرأي العام في كلا البلدين وكذلك للسياسيين.
وسيكون من الخطأ اعتبار تصريحاته مجرد آراء شخصية أو كراهية متجذرة تجاه بلدنا أو "عقدة المستعمر"، كما يزعم بعض المحللين الجزائريين. فالتحليل البارد لتصريحاته يكشف أهداف مهمته، وخاصة الجملة الواردة في كتابه الأول، والتي تقول: "العلاقات مع الجزائر تمثل في الوقت نفسه قضية سياسة خارجية وداخلية لفرنسا". هل هناك أوضح من ذلك؟ لقد كان المؤسس لدبلوماسية التأشيرات، مما دفع فرنسا إلى اتخاذ قرار أحادي الجانب بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين بنسبة 50% (وكذلك للمغاربة)، بحجة أن بلادنا "تتلكأ" في قبول إعادة مواطنيها المدانين بجرائم مختلفة (قرارات الطرد).
وبالتالي، كان يملك مفاتيح "حنفية" التأشيرات، زيادة أو نقصانًا، للتفاوض بها كما يفعل التجار في سوق الماشية، ويقترح اليوم على السلطات الفرنسية الحالية استخدام هذا "السلاح" والتمادي في استعماله للضغط على الموقف الجزائري، لاسيما في ما يتعلق بإعادة التفاوض بشأن اتفاقيات 1968 التاريخية، والتي يعتبرها مجحفة لصالح الجزائريين مقارنة بدول المغرب الأخرى.
ومن المنطقي تمامًا أن يصرّح دريونكور بأن "المشكلة في السياسة الداخلية الفرنسية تجاه الجزائر هي في ديمقراطية النظام الجزائري"، الذي يصفه بأنه سياسي-عسكري، وأن بلادنا مهددة بـ"الانهيار الذي سيجر فرنسا معه". ومن هنا يستنتج – ضمنيًا – أن على فرنسا الاحتفاظ بحق التدخل في السياسة الداخلية للجزائر، لإجبارها على الدخول في مسار "ديمقراطي" يربطه بحراك الشعب. ونأمل ألا يلقى هذا السفير السابق نفس مصير سلفه، جان فرانسوا باجوليه، الذي وُضع مؤخرًا تحت التحقيق بتهمة ابتزاز الأموال.
ومع ذلك، تشير الإحصاءات الفرنسية إلى أن عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين تراجع من 420,000 إلى 15,000 خلال السنوات الثلاث الماضية… وهو ما سيدفع بعض السياسيين لاقتراح مفهوم جديد للهجرة، أُطلق عليه "الهجرة الانتقائية"، مراعاةً للشيخوخة الديمغرافية.
وهكذا، وأثناء زيارة وزير الداخلية الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى الجزائر، اقترح أن تقتصر الهجرة على أصحاب الشهادات (أطباء، مهندسون، تقنيون سامون، ممرضات…) أي، النخبة الجزائرية التي تم تكوينها مجانًا بأموال الخزينة العمومية.
كل المرشحين المحتملين يستعدون لمعركة الانتخابات الرئاسية لعام 2027، وإن لم يصرحوا بذلك، مركزين جهودهم مع طواقمهم الرسمية وغير الرسمية لخوض هذا التحدي بجميع الوسائل المتاحة. وتشير التجارب الانتخابية السابقة إلى أن الفارق بين الفائز والخاسر لم يتجاوز 1 إلى 2% من الأصوات، باستثناء انتخابات شيراك/لوبان.
وإذا ما قُدّر عدد الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا بجميع فئاتها بـ7 ملايين شخص، ومع وجود نحو 30 مليون ناخب محتمل ضمن 69 مليون نسمة، فإن 3 إلى 4 ملايين صوت قد تقلب موازين الجولة الثانية لصالح هذا المرشح أو ذاك! ينبغي الاحتفاظ بهذا الرقم التقديري، رغم تعقيدات الواقع (تيارات سياسية، نسب الامتناع، الولاءات، الوضع الاقتصادي، أعمار الناخبين…).
يُقدّر عدد مزدوجي الجنسية من أصل جزائري في فرنسا ما بين 5 إلى 6 ملايين شخص، ما يجعلهم يمثلون حوالي 3 إلى 4 ملايين ناخب محتمل في الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو ما قد يرجّح الكفة لصالح المرشح الذي يتمكن من كسب هذا الجمهور الانتخابي! هذا هو جوهر الرهانات القادمة، ولهذا السبب بالذات يجري تضخيم ملف الهجرة بشكل مبالغ فيه، خاصة ما يتعلق بالجالية الجزائرية دون غيرها.
جميع القوى السياسية تدرك تمامًا هذه الحقيقة الديموغرافية والسياسية، وتبعاتها على الانتخابات عمومًا، والرئاسية على وجه الخصوص. وعلى الرغم من أن تصويت هؤلاء ليس متجانسًا بالكامل، إذ قد يصوّت البعض لليمين بل حتى لليمين المتطرف، فإن الاتجاه الغالب – كما هو الحال مع كل الأقليات في العالم – يميل نحو المرشحين ذوي التوجهات اليسارية. وتشير المؤشرات إلى أن المرشح الأكثر حظًا في 2027 سيكون من تيار الوسط-اليميني، حتى وإن لم يكن مدعومًا بحزب سياسي قوي أو تمويل معتبر.
لم يفاجأ أحد باعتراف إيمانويل ماكرون بـ"مغربية" الصحراء الغربية، إذ يرى في ذلك ورقة جديدة لقلب ميزان القوة لصالح فرنسا. ويؤكد دريونكور أن "الجهود التي بذلتها فرنسا تجاه الجزائر لم تقابل بالمثل"، ويقترح تبعًا لذلك تقاربًا مع المغرب.
هذا التحول الفرنسي، الذي يتعارض مع مواقفها السابقة الداعمة لقرارات الأمم المتحدة بشأن إجراء استفتاء لتقرير المصير، سيدخل علاقاتنا في مرحلة جديدة من التوتر، وقد أُلغيت الزيارة الرسمية المرتقبة في سبتمبر دون تحديد موعد بديل في أجندة البلدين.
يبدو لي أن أنسب وصف لهذا المسلسل هو كلمة "هزلي"، في إشارة إلى ما يُعرف اليوم بـ"قضية بوعلام صنصال"، الموصوف زيفًا بـ"المواطن الجزائري". فقد استخدمت مصطلحات مثل الضغوط الدبلوماسية والقنصلية، استدعاء السفراء للتشاور، ميزان القوى... لوصف هذه "التدخلات" المتكررة، بل الزائدة عن الحد!
وترتبط هذه الوضعية، من الناحية الفعلية والقانونية، باعتقاد فرنسا الدائم أن المغرب العربي وغرب إفريقيا يُمثلان عمقها الاستراتيجي "المملوك"، خصوصًا الجزائر التي كانت، قبل الاستقلال، ثلاثة أقسام إدارية فرنسية. ومنذ أن رفضت الجزائر هذا الميثاق الاستعماري لأسباب تاريخية، تصادمت رؤيتان استراتيجيتان بدل أن تتكاملا، إذ يرى كل طرف نفسه صاحب الشرعية ويتصرف دون التشاور مع الآخر.
أما الآن، فهناك خياران لا ثالث لهما: المواجهة أو التعاون. ولسوء الحظ، اختارت فرنسا المواجهة في المنطقة مع الجزائر، بحجة الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والمالية والثقافية... مع عرقلة كل المبادرات الجزائرية الهادفة لتعزيز موقعها كـ"دولة محورية" في المنطقة. ومثال ذلك في مالي، حيث لعبت الجزائر دورًا مهمًا عبر قوتها الناعمة للتوصل إلى "اتفاق الجزائر"، الذي كان من شأنه إنهاء الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب. غير أن التدخل العسكري الفرنسي (عملية برخان) لم يُحل الأزمة، بل دفع البلاد إلى دوامة جديدة من الحرب الأهلية واحتمال التقسيم. وكان من الأفضل لفرنسا دعم اتفاق الجزائر بدلاً من تعقيد الوضع.
والنتيجة: فشل كامل وتقلص كبير في التواجد المدني والعسكري الفرنسي في إفريقيا، بناءً على طلب تلك الدول. وتم التشويش على كل محاولات التقارب بين البلدين عبر "قضية صنصال" أو عبر المؤثر بوعلام، في حملة إعلامية فرنسية مكثفة. باختصار، كلما اقتربت العلاقات الثنائية من الانفراج، تدخلت قوى اليمين المتطرف لإفسادها عمدًا. وكان ماكرون قد صرّح قبل عامين: "هناك من يسعى بكل جهده إلى إفشال ما نقوم به مع الجزائر منذ سنوات… لكن لدي رسالة واضحة: سأواصل"، مشيدًا بـ"صداقة الرئيس عبد المجيد تبون، والتزامه بالمضي قدمًا في تطوير العلاقات الثنائية".
لا يمكن تصور العلاقات الجزائرية-الفرنسية إلا من خلال رؤية متوسطة وطويلة الأمد، قادرة على تجاوز التقلبات التي تفرضها علينا الجغرافيا والتاريخ. لا يمكن تطبيع هذه العلاقات ما دامت قائمة على المشاعر والانفعالات.
وقد تخلّصت الجزائر من حاجتها للتمويل الخارجي ومن مديونيتها، وتملك اليوم فرصًا استثمارية هائلة في كل المجالات، لا سيما التعدين، البنى التحتية، الصناعة، الفلاحة، السياحة… وغيرها من القطاعات التكنولوجية.
بإمكان فرنسا الاستفادة من هذه الفرص في إطار من التنافس الشريف، لبناء علاقات مثمرة بعيدًا عن المزايدات العنصرية والسلوكيات الأبوية التي يفرضها الخطاب السائد. وإذا ما تركت فرنسا نفسها رهينة للأحداث اليومية، فإن بلدانًا أخرى لن تتردّد في ملء الفراغ. ولن يكون عليها سوى لوم نفسها.